27 تموز 2024
27 شباط 2023
.jpg)
كيف يمكن للمرء أن يكون صهيونياً ويسارياً في الوقت نفسه؟ تبدو المفارقة غير عقلانية لكنّها واقعية، في تصادم مع القانون الهيغلي المثالي في أنّ «كلّ ما هو واقعي عقلاني، وكلّ ما هو عقلاني واقعي». غير أنّ حبل هذه الواقعية غير المستندة إلى العقل يبدو قصيراً. فمطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باحت الانتخابات الإسرائيلية بنتائجها التي لم تكن أهمّها عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة ترفده أحزاب الصهيونية الدينية، إنّما الهزيمة النكراء التي مُني بها «اليسار الصهيوني»، وعلى رأسه حزب العمل الذي لم تتجاوز مقاعده الأربعة في الكنيست الجديد.
هزيمة تلخّص مساراً انحدارياً. فهذا الحزب الذي أسس «الدولة» وحكمها شبه منفرد أكثر من ثلاثة عقود حتى نهاية السبعينيات ظلّ يتراجع إلى أن بلغ هذا المستوى من التمثيل المجهري، شأنه شأن بقية أحزاب اليسار في الدولة العبرية. وهي أحزاب تمرّ بأزمة مديدة لا تنبع فقط من قوّة منافسيها بل من طبيعة تكوينها الفكري وخطها السياسي. هنا، يسعى المؤرخ الفرنسي المناهض للصهيونية توماس فيسكوفي[1]، في كتابه L’Échec d’une utopie: une histoire des gauches en Israël [إخفاق يوتوبيا: تاريخ لليسار في إسرائيل] الصادر عن دار La Découverte، إلى تشريح هذه الأزمة عبر تحليل النقاشات التي شقّت حركاتها وقسّمتها منذ نشأتها.
ينطلق الكتاب من مراجعة تاريخية عميقة لتشكُّل حزب «ماباي» (عمّال أرض إسرائيل) بقيادة دافيد بن غوريون في 1930، بوصفه الحركة اليسارية الصهيونية التي ستنبثق منها لاحقاً غالبية الأحزاب اليسارية في الكيان، والسلف الأساسي لحزب العمل الحالي. ثم يبلغ لحظة السبعينيات الفارقة التي بدأت منها أزمة اليسار تتطوّر مع الزمن مروراً بعقد التسعينيات وجدل «السلام» مع «منظمة التحرير» وما ترتَّب عنه من انحدار متسارع لشعبية التيار واهتراء قاعدته الاجتماعية، وصولاً إلى حالة السيولة الفكرية والسياسية التي انتهى إليها بعد ذلك.
قومية مغلَّفة بالاشتراكية
يذهب توماس فيسكوفي إلى أنّ الصهيونية لم تكن يوماً متجانسة. فمنذ نشأتها في القرن التاسع عشر لم تستقر طبيعتها الفكرية على حال، وعبّرت عنها أصوات مختلفة بتعريفات شتّى. بالنسبة إلى البعض، كان على الصهيونية أن تتحالف مع الرأسمالية الغربية، وأن تحصل على الدعم الدبلوماسي، وتركِّز على شراء الأراضي من أجل إقامة دولة على أسس ليبرالية.
بالنسبة إلى الآخرين، إذا كانت الصهيونية هي السبيل الوحيد لـ«تحرير الذات» من معاداة السامية، فإنّ الهجرة بعيداً عن المجتمعات الأوروبية المعادية للسامية، وهي في جوهرها «رحلة من أجل تحرير الذات»، يجب أن تكون فرصة لتحقيق «ثورة قومية». يتقاطع نموذج التحرُّر والثورة هذا منطقياً مع الأفكار الرائجة في أوروبا وقتذاك، بدءاً من الماركسية أو الاشتراكية الديموقراطية. وقد نجح الصهاينة في إقناع قطاع واسع من النخب الغربية – الأحزاب الشيوعية أساساً وجزء من الأحزاب الديموقراطية الاشتراكية – بمشروعهم السياسي رغم طبيعته المتناقضة: إقامة دولة لليهود على أسس اجتماعية، لكن بالمزج بين القومية والاشتراكية.
يعرَّف المؤرخ زئيف ستيرنهيل الصهيونية اليسارية على نحو أكثر دقّة بأنّها «قومية مغلَّفة بالاشتراكية». ولم يكن هذا المشروع التحرّري واليساري أقل استعمارية قياساً بأشكال الاستعمار الأوروبي السائدة آنذاك. فالحركة الصهيونية لا تطالب بحق السيادة لليهود فحسب إنّما بالحق في الاستقرار على أرض كان عددهم عليها قليلاً: أقل من 5٪ من سكان فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر. هذا هو جوهر القصة التي يحكيها فيسكوفي في كتابه. ففي الوقت الذي ترسَّخ المشروع الصهيوني في فلسطين، بين 1948 و1967 على وجه الخصوص، كيف استطاع هؤلاء الاستمرار في تعريف أنفسهم أنّهم يسار؟ ماذا تعني لهم تسمية اليسار هذه؟
لقد نجحت هذه الصهيونية اليسارية منذ عشرينيات القرن الماضي في السيطرة على الهيئات اليهودية والصهيونية الرئيسية كافة في فلسطين، مثل «المجلس الوطني اليهودي» و«الوكالة اليهودية». يرجع ذلك أساساً إلى أنّها كانت قادرة على تولّي المسؤولية وتقديم إطار للاندماج والعمل للقادمين الجدد، خاصة في ظلّ إنشاء شبكات الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية) والكيبوتس (تجمّع سكني تعاوني يضم جماعة من المزارعين أو العمال اليهود الذين يعيشون ويعملون معاً).
يشير الكاتب إلى أنّه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت النظرية الصهيونية الاشتراكية لتحرير اليهود من معاداة السامية عبر توطينهم على أرض يعيشون فيها في مجتمع مُدار ذاتياً بالكيبوتس، وكان من روّاد هذه المدرسة: دوف بير بوروشوف، وسيركين نحمان، وموسى هيس، وأهارون ديفيد غوردون. قد يبدو الكيبوتس، إذا أخذناه خارج سياقه الإسرائيلي، نموذجاً للحياة الجماعية القائمة على المساواة والمشاركة، لكنّه يغدو استعمارياً بصورة جليّة في سياقه الفلسطيني خاصة بوصفه مستوطنة يجري داخلها تجميع وتدريب مستعمرين بهدف التوسع نحو احتكار المزيد من الأراضي.
أما الهستدروت، فكان نشاطه يصبّ أساساً في خانة توحيد العمال اليهود كافة في فلسطين في ظلّه. وبتطوير هذه المنظّمة شبكات التعليم الخاصة والمصارف والتأمين والنظام الصحي، سمح الهستدروت للصهاينة اليساريين بوضع الهياكل الأساسية كافة للدولة المستقبلية، وأن يكونوا قادرين على تنظيم العمال نحو هدف واحد: إنشاء الدولة.
لذلك، يضع توماس فيسكوفي كلاً من الهستدروت والكيبوتسات في خانة الأدوات السياسية المركزية للمشروع الصهيوني لكسب دعم وتعاطف الاشتراكيين في أرجاء العالم. هذا ما سيدفع أنظمة الاشتراكية الديموقراطية الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في أوروبا، إلى تقديم تمويلات سخية للحركة على غرار فرنسا وألمانيا ودول اشتراكية شرقي القارة.
كانت الحركة الصهيونية اليسارية تحشد طاقتها لتمويه استعمارها خلف الادعاءات الاشتراكية والثورية التي تجسّدت في تجربة «الكيبوتزنيك»، أو القوّة النقابية للهستدروت. ويعتقد الكاتب أنّ الهيكلين كانا يعملان في خدمة قيادة حزب العمل أكثر من اهتمامهما بالتجارب الاجتماعية المتخيَّلة داخلهما، أو بقدرتهما على توحيد يهود فلسطين وتنظيمهم.
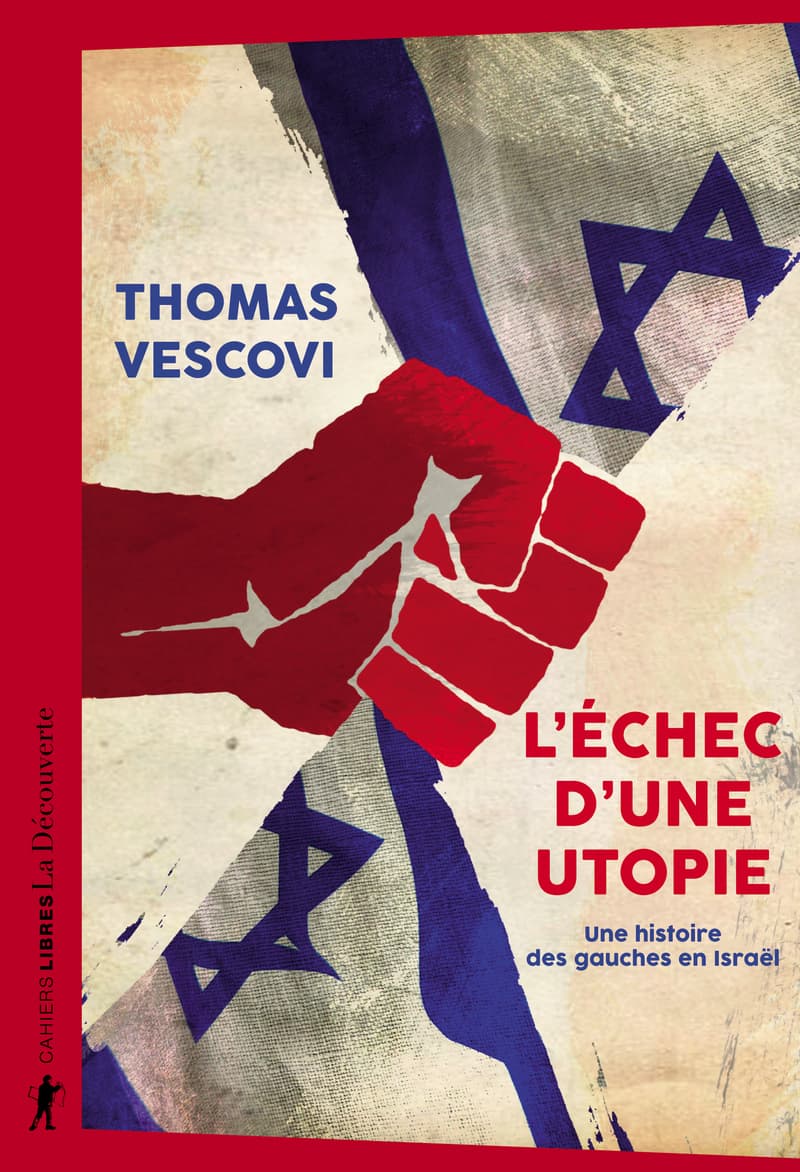
غلاف كتاب فيسكوفي الصادر عام 2021 (La Découverte)
يعود الكاتب في تحليله طبيعةَ القاعدة الاجتماعية لليسار الصهيوني إلى السنوات الأولى ما بعد تأسيس الكيان، وتحديداً خمسينيات القرن الماضي وستينياته عندما رحّبت إسرائيل بمئات الآلاف من اليهود الشرقيين القادمين من الدول العربية: العراق ودول شمال إفريقيا واليمن. في ذلك الوقت، أراد بن غوريون والصهاينة اليساريون «إحداث ثورة ثقافية»، أي فصل هؤلاء عن ثقافتهم وتحويلهم إلى أسلوب حياة مماثل ليهود أوروبا، «فالمهاجرون الجدد الذين وصلوا إلى دولة تُقدَّم لهم على أنّها موطن اليهودية ليس لديهم المفهوم نفسه عن اليهودية مثل الغالبية الأشكناز الذين يريدون فصل الدين عن الدولة».
تضاف إلى سوء الفهم هذا الإهانات التي عانوا منها، إذ فُرِضت عليهم ملابس جديدة غربية، وجرى حشرهم في معسكرات انتقالية ذات ظروف معيشية مهينة وبعيدة عن مناطق العمل. مثلاً انفصل آلاف الأطفال اليمنيين عن آبائهم «من أجل التطعيم»، ثم أعلنوا وفاتهم. لكن في حين أنّ بعضهم ماتوا بالفعل، وُضِعت الغالبية لدى عائلات يهودية غربية.
غرباء عن هذه الممارسات تعرّض «يهود الشرق» إلى التمييز ليس بسبب دينهم إنّما بسبب ثقافتهم، أو لون بشرتهم، أو أصلهم. وهو ما سيزرع بينهم منذ ذلك الحين الاستياء من الصهاينة اليساريين العلمانيين لمصلحة حشد جماهيري لليمين القومي الذي كان يمثّله حزب «حيروت». «فقد أدى تراكم الميز العنصري، وإرادة تغريبهم المفروضة من قيادة "العمل" والدولة بوصفه حاكمها، إلى مزيد من الانكماش الاجتماعي لدى قطاع كبير من اليهود الشرقيين، والعودة إلى الدين، وتالياً الاقتراب من اليمين الذي كان واعياً بهذه الظاهرة ومستغلاً لها». بفضل تصويت «يهود الشرق»، سيغدو مناحيم بيغن رئيساً للوزراء عام 1977، ويستولي اليمين الصهيوني على السلطة.
أيضاً يعود فيسكوفي إلى محاولة تمرّد يساري ليهود شرقيين جسّدتها حركة «الفهود السود» في أوائل السبعينيات، وهي حركة اجتماعية - سياسية أسّستها شخصيات مهاجِرة من الجيل الثاني من «يهود البلدان الإسلامية»، مثل سعدية مارسيانو وروفين أبيرجيل. انشقّ هؤلاء عن اليسار الصهيوني (العمل) لقيادة احتجاج على التمييز الاجتماعي الذي كان يمارسه اليهود الغربيون بحق الشرقيين على صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتمثيل السياسي، ثم طوَّروا مواقف أكثر قرباً من الجانب الفلسطيني وصاروا يدعون إلى السلام.
لقد أدى إخفاق هذه الحركة وقمعها في حكم «العمل» إلى تعزيز استياء هذا المجتمع من اليسار، وميله أكثر نحو أحزاب اليمين الصهيوني القومي والصهيونية الدينية. وفي مسار انتقامي من السلوك القمعي لحكومة «العمل»، صارت هذه القاعدة بمرور الزمن وضعف التعبئة الأيديولوجية والسياسية للحركة تَنزع شيئاً فشيئاً نحو محافظة سياسية أكثر يمينية، ولا سيّما في اتجاه اليمين الديني الصهيوني.
برز خلال التسعينيات عدد من السياسيين الإسرائيليين المنحدرين من أصول شرقية لكنّهم يتبنّون مواقف أشد يمينية من نظرائهم داخل اليمين. بينهم المهاجر المغربي دافيد ليفي، الوزير السابق والقيادي في «الليكود»، والكردي إسحاق مردخاي الذي انضم في 1995 إلى هذا الحزب وعُيّن في العام التالي وزيراً للأمن بعد فوز بنيامين نتنياهو في انتخابات رئاسة الوزراء.
تسعينيات الانحدار
عام 1993، وقّع رئيس الوزراء زعيم حزب العمل إسحاق رابين اتفاقات أوسلو مع ياسر عرفات. يَذكر الكاتب بإسهاب النقاشات داخل اليسار الصهيوني، التي أدّت إلى قبول المفاوضات مع الزعيم الفلسطيني. وينقل عن ناشط السلام أوري أفنيري – أوّل إسرائيلي قابل عرفات، وكان ذلك عام 1982 خلال حصار بيروت – طبيعة هذه النقاشات: «رأى أفنيري أنّ زملاءه داخل اليسار منقسمون بين جناحين: جناح عاطفي، وآخر سياسي. لقد جمع الجناح العاطفي غالبية من الأعضاء كانوا يركّزون على قضايا داخلية في إسرائيل. كانوا مهتمين قبل كلّ شيء بالصورة التي أعطيت عنهم وعن دولتهم في الخارج. في هذا النمط من التفكير، كان سعيهم إلى منح الفلسطينيين بعض الحقوق يقتصر على هدف تعزيز صورتهم الأخلاقية فقط، ولم يجرِ أبداً اعتبارهم شركاء على قدم المساواة. وفي المقابل، رأى الجناح السياسي أنّ السلام يتطلب مراعاة متبادلة لتطلعات ومشاعر ومخاوف وآمال الشعب الفلسطيني. وكان رابين من رموز الجناح الأوّل، وحالما انتصر انتخابياً وشرع في مسيرة أوسلو، سيطر الجناح العاطفي تماماً على حزب العمل».
يعتقد فيسكوفي أنّ عقلية رابين تطوّرت من كونه رئيس أركان جيش الكيان إبّان حرب 1967، بكلّ ما يعنيه ذلك من رغبة في إبادة «العدو» الفلسطيني والعربي، إلى كونه رئيس حكومة يقبل فكرة أن يكون للشعب الفلسطيني دولة. غير أنّ هذا التطوّر كان نسبياً ونفعياً، إذ لم تبلغ درجته مستوى مراعاة تطلّعات الشعب الفلسطيني في قضايا السيادة واللاجئين، ولذلك «لم يكن تحوّل الصهيونية اليسارية إلى مرحلة الحوار مع الفلسطينيين نابعاً من يقين بحتمية السلام بقدر ما كان سعياً خلف تأمين مصالح اليهود حصراً».
استغلّ اليمين ذاك السياق للاستثمار في الخوف داخل المجتمع الإسرائيلي، عادّاً «السلام» على هشاشته تطبيعاً مع «إرهاب منظمة التحرير». ونجحت خطته في العودة إلى السلطة عام 1996 بفوز نتنياهو برئاسة الوزراء في أعقاب اغتيال رابين، علماً أنّ «العمل» بزعامة إيهود باراك سيستعيد موقعه بعد ثلاث سنوات، في لحظة بدت أساسية في تاريخ اليسار الصهيوني، وفق فيسكوفي.
قامت حملة باراك على شعارات العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أربع سنوات صعبة شابها عنف واسع النطاق وسط شعور الفلسطينيين بالخداع بعد «أوسلو». يقول الكاتب إنّ باراك أرجأ بمجرّد توليه منصبه المواعيد النهائية المنصوص عليها في الاتفاقات، وصدّق على بناء مستوطنات جديدة، وزار مستوطني الخليل، أكثر المستوطنين تعصّباً، لطمأنتهم بشأن المحادثات المستقبلية.
في ربيع 2000، انعقدت قمة كامب ديفيد بينه وبين أبو عمّار الذي ذهب إلى طاولة التفاوض بضغط من بيل كلينتون، وعاد خائباً «بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نهجه في أربع نقاط: القدس ستبقى العاصمة الواحدة غير القابلة للتجزئة لإسرائيل، وإلغاء الخط الأخضر الذي يفصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، والحفاظ على 80٪ من المستوطنات، ورفض حق العودة». ويرى فيسكوفي أنّ «باراك كان يسعى إلى رفع سقف المزايدة الصهيونية في مواجهة اليمين القومي والصهيونية الدينية لكن في الواقع كان الأمر انتحاراً سياسياً».
.jpg)
مهجّرون فلسطينيون من قريتهم قرب حيفا عام 1948 (Corbis)
يعتقد الكاتب أنّ اليسار الإسرائيلي ممزّق حتى الآن بين ديناميكيتين. إحداهما، وهي لأقلية تقتصر على ما يسمّى اليسار غير الصهيوني أو المناهض للاستعمار، ترى أنّ المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن تبدأ من مسلّمة أنّهم مظلومون ومستعمرون. أما اليسار الآخر، المرتبط بحزب العمل التاريخي، فيقبل المفاوضات من أجل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية بدءاً من الدفاع عن الطابع اليهودي لدولته.
بمعنى آخر: لا يهتم هذا التيّار بالتطلّعات الوطنية للشعب الفلسطيني بقدر اهتمامه بوسائل الحفاظ على دولته، ووضع مسألة الأمن في قلب اللعبة. هذا ما يفسّر إخفاق أوسلو ختاماً، بعدما جاء عرفات ورابين إلى طاولة المفاوضات بتوقّعات مختلفة. كان أبو عمّار «يأمل في الحصول على دولة حرّة ومستقلة، فيما يريد رابين التفاوض على انفصال ودّي بين المجتمعين وترك الفلسطينيين مع استقلال ذاتي. ولم يخطر في بال المفاوضين الإسرائيليين في أيّ وقت من الأوقات أن يطرحوا إنهاء الاحتلال».
أفضى إخفاق أوسلو إلى تفضيل ديناميكية أخرى جسّدها آنذاك شارون ونتنياهو اللذان يعتقدان أنّه يجب الفصل بين المجتمعين بالقوّة وعلى أساس المصالح الإسرائيلية فقط، دون أن يكون شكل الانفصال استقلالاً ضمن نموذج «حلّ الدولتين».
فقدت الصهيونية اليسارية قناعها التقدّمي وظهر بوضوح طابعها المحافظ والاستعماري خاصةً برفضها منح «حقوق متساوية للعرب» الذين يعيشون داخل «حدودها» والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية في وطنهم. ويشير الكاتب أيضاً إلى عامل أساسي أدّى إلى تراجع اليسار الصهيوني هو التحوّل النيوليبرالي العالمي: «الدولة التي أسّسها حزب العمل في العقود الأولى من وجود إسرائيل، والقائمة على مبادئ العلمانية والتضامن بين العمال اليهود، لم تعد موجودة. صارت إسرائيل الآن مندمجة تماماً في الرأسمالية الغربية وتحوّلت إلى محضنة لروّاد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الجديدة. أما داخل المجتمع، فاستبدلت موجات الإصلاح الاقتصادي منذ 1980 الروح الجماعية بالفردانية، فيما عفا الزمن على القيم الاشتراكية، على عكس قيم القومية الدينية الصاعدة بقوّة».
توترات الصهيونية
يخلص فيسكوفي إلى أنّ الصهيونية اليسارية أخفقت لأسباب بنيوية تتعلّق أساساً بطبيعة قاعدتها الاجتماعية التي أخذت في الانحسار منذ الثمانينيات. ويبرهن على ذلك باستطلاع أجراه «معهد الديموقراطية» في إسرائيل في شباط/فبراير 2020، وفيه يُعرّف 69,9٪ من اليهود الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً أنفسهم بأنّهم «يمينيون». وفي أيلول/سبتمبر 2019، ذهب 41٪ فقط من الأطفال الإسرائيليين إلى مدرسة عامة علمانية، بينما كانوا يشكلون الغالبية قبل أقلّ من عشر سنوات.
غير أنّ الكاتب يقول: «لا يزال هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تظلّ اليوتوبيا الصهيونية اليسارية حقيقة سياسية بالنسبة إليهم: تشكيل دولة لليهود لكن على أسس علمانية واجتماعية. وهذا ما يجعل السياسة الإسرائيلية تمرّ اليوم بتوترين. أولاً داخل الحركة الصهيونية حول هوية هذه الدولة اليهودية: علمانية أو دينية؟». ينظر اليهود الأشكناز (الأوروبيون) إلى الصهاينة اليساريين على أنّهم مناهضون لرجال الدين، ويتصوّرون اليهودية أنّها مجرّد انتماء ثقافي. في المقابل، تفضّل حالياً الطبقات المتوسطة والغنية ذات النزوع العلماني الليبرالي المرشحين من الوسط القادرين على الجمع بين الليبرالية و«الفصل بين الدين والدولة»، وهذا حال يائير لابيد، المنافس الرئيسي لنتنياهو. أما الطبقات الشعبية، ولا سيّما من اليهود الشرقيين، فميلها واضح نحو اليمين بشقّيه القومي والديني.
يشمل التوتر الثاني المجتمع الإسرائيلي بأسره، وهو يتساءل عن شكل هذه الدولة: «يهودية حصراً؟ هل تستوعب غير اليهود؟». فقد صار التوجّه نحو إقرار يهودية الدولة يضع النظام السياسي الذي ولد عام 1948 على قاعدة «تحريرية واشتراكية» تغذّيها «مظلومية تاريخية»، في تناقض صارخ بين القبول بالمواطنة بوصفها قيمة فوق عرقية ودينية، وبين تكريس طابع عرقي - ديني للدولة.
لكن بقدر ما تبدو الصراعات الإسرئيلية الداخلية مهمةً في مسار الصراع العربي - الصهيوني، فإنّها ستكون في مقام ثانٍ قياساً بالسياقات الدولية. يقول الناشط الثوري المناهض للصهيونية ميشال ورشاوسكي[2] في مقدمة وضعها لكتاب فيسكوفي: «هناك شيء واحد مؤكّد هو أنّ مستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي لن يكون في الأساس نتاج صراع داخلي في المجتمع الإسرائيلي. بل إنّ ذلك سيكون رهناً بالسياقات الإقليمية والدولية. إنّ تقدّم الثورة العربية ونكساتها، والتطوّرات داخل جماعات الإسلام السياسي، وانهيار نظام سايكس - بيكو، والدول التي أسّستها القوى الإمبريالية قبل قرن، ستؤثّر أكثر في مستقبل إسرائيل والصراع الاستعماري في البلاد. فلسطين أكبر من أيّ انتصار لنتنياهو على "العمل" أو انتفاضة مفيدة من معسكر السلام الإسرائيلي».
[1] باحث فرنسي مستقل في التاريخ المعاصر، مؤلف La Mémoire de la Nakba en Israël [ذاكرة النكبة في إسرائيل] الصادر عن L’Harmattan في باريس عام 2015.
[2] صحافي وناشط إسرائيلي (1949) من أقصى اليسار، وهو مؤسّس مشارك ورئيس مركز المعلومات البديلة في القدس، والرئيس الأسبق للرابطة الشيوعية الثورية الماركسية الإسرائيلية. وهو معادٍ للصهيونية، ويطالب باستبدال الدولة اليهودية بدولة ثنائية القومية. عام 1989، حُكِم عليه بالسجن عشرين شهراً بتهمة «تقديم خدمات إلى منظمات غير مشروعة»، وذلك بطباعة منشورات تتعلّق بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
كاتب صحافي تونسي، وباحث مهتم بالعلوم الاجتماعية، صدر له: بنادق سائحة: تونسيون في شبكات الجهاد العالمي (2016)؛ المجموعة الأمنية: الجهاز الخاص للحركة الإسلامية في تونس (2017)؛ عشر ساعات هزّت تونس.. حريق السفارة الأمريكية ونتائجه (2019)؛ التاريخ السرّي للإخوان المسلمين في تونس (بالإنجليزية 2020).